34 – هل تعلم لماذا يجب أن تعرف ما هي القواعد الفقهيّة ومعانيها وتطبيقاتها؟
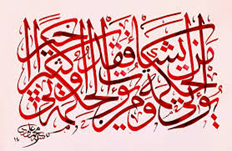
مقدمّة ومدخل
الحمد لله وحدة والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده، اللهم لا علم لنا إلا ما عَلّمْتَنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم عَلِّمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما عَلَّمتنا وزدنا علماً؛ واجعلنا ممن يستمعون القول فيتّبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.
القواعد الفقهية هي مبادئ قانونية عامّة صيغت بإيجاز من كلمات قليلة لكنّها معبّرة عن الفكر القانوني والحقوقي الإسلامي متميّزة بالشمول والتكامل؛ وهي “من أهمّ العلوم الإسلامية، وهي مرحلة متطورة للتأليف في الفقه، وضبط فروعه، وإحكام ضوابطه، وحصر جزئياته، ولها فوائد جمة، ومنافع كثيرة. وهو فن عظيم، تجمع فيه الأحكام الفرعية العديدة، والمسائل الجزئية المتناثرة في عبارات وجيزة، وجمل مصقولة، وتراكيب عامة شاملة، تضبط علم الفقه، وتنسق علله وأحكامه، وتقربه للأذهان، وتجعله سهل الحفظ والضبط، وتبعده عن النسيان، وتساعد في تكوين الملكة الفقهية”[i]. استنبط العلماء الأبرار هذه القواعد إمّا من النصوص الشرعية التي تدُلّ على القاعدة بشكل مباشر أو بوحيٍ من هذه النصوص، ولو اختلف هؤلاء أحيانًا في صياغة القواعد التي قبلوها جميعًا، ولو اختلفوا في قبول البعض منها، لكنّها تبقى جميعًا على دلالاتها ومعانيها وفوائدها.
أمّا من حيث الوظيفة، فكلّ قاعدة من القواعد الفقهيّة أشبه بالوعاء الذي يجمع الجزئيات المتفرقة المبعثرة في كيان واحد متماسك مستقل، أو مثل جذع شجرة يضم بوحدة بين حناياه كافة الأغصان المترامية، والأوراق المتنوعة والثمار المتطاولة.
وللقواعد الفقهية مكانة كبيرة بين علوم الشريعة وبين دارسيها وحتى بين الناس عامّة، بسبب دلالاتها العظيمة، ونظرًا لما تحقّقه من فوائد ومنافع جمّة للدارسين والفقهاء والقضاة والمفتين والمجتهدين وحتّى لأيّ مسلم ليستزيد من العلم والفقه والتفقّه.
لكن دعونا أولًا نبدأ من البداية: أن ننطلق من معنى القواعد الفقهية في اللغة العربيّة وفي الاصطلاح.
معنى القواعد الفقهية
القواعد: جمعٌ مُفْرَدُه قاعدة، وهي ذات معانٍ عدة عند أهل اللغة منها: الأساس، والقواعد دعائم كل شيء كقواعد الإسلام وقواعد البيت وغيرها، وقواعد البناء: أساسه، قال تعالى: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [البقرة:127]، والقاعدة أصل الأُس، وتجمع على قواعد، والأس: الشيء الوطيد الثابت، وجمعه أسس، والقواعد الأساس، وقواعد البيت أساسه.
الفقهية: نسبة إلى الفقه، والفقه لغة له معان أساسية ثلاثة؛ هي: الفهمُ، والعلم بالشيء، والفطنة والذكاء، تقول: فقه الرجل، بالكسر وفلان لا يفقه وأفقهتك الشيء ومنه قوله تعالى: ﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ [الإسراء:44]، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: ((من يرد الله به خيرًا، يُفقهه في الدين))[ii]؛ كل ذلك بمعنى الفهم، ثم خصّ به علم الشريعة، والمشتغل به فقيه. وفي الاصطلاح: “الفقه: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية“.
أمّا معنى قاعدة فقهية في الاصطلاح فقد عُرِّفت بتعريفات كثيرة منها ما عَرَّف به الدكتور علي أحمد الندوي بِأنَّهَا: “حكم شرعي في قضية أغلبية يتعرف منها أحكام ما دخل تحتها“؛ كما بيّن الحموي، أحمد بن محمد مكي “إن القاعدة هي عند الفقهاء غيرها عند النحاة والأصوليين، إذ هي عند الفقهاء حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها“. ويقول د. محمد مصطفى الزحيلي عن علم القواعد الفقهية: “هو فن عظيم، تجمع فيه الأحكام الفرعيّة العديدة، والمسائل الجزئية المتناثرة في عبارات وجيزة”.
مراحل تدوين القواعد الفقهية
المرحلة الأولى – البذور: وضع النبيّ محمد صلى الله عليه وسلم اللبنة الأولى للقواعد الفقهيّة مع نزول الوحي وتبيان أحكام شؤون الحياة. وهو الذي أُعْطِي جوامع الكلم، ما قلّ من الكلام ودلّ على الكثير، وما يحمل الكثير من المعاني بالقليل من الألفاظ، بعيداً عن التصنّع والتكلّف، كما في الحديث الشريف: ((أعطيت جوامع الكلم))[iii]. وهذا ممّا يسّره الله له وفضّله من البلاغة والفصاحة برز بهما بين العرب وهم أهل البلاغة والفصاحة، وما اختصه به من الحكمة البديعة والتعابير الحسنة، لذلك أصبح العديد من الأحاديث النبويّة الشريفة قواعد كليّة جاهزة أو خامة أساس لصياغة هذه القواعد.
في هذه المرحلة نزلت الأحكام الجزئيّة متفرقة مع القرآن الكريم والسنة الشريفة حسب مقتضيات الأمور والمستجدات خلال البعثة النبويّة الشريفة، ونجد الكثير من الأمثلة على هذه الفصاحة والبلاغة مثل ((إنما الأعمال بالنيات))، ((من أحْدَثَ في أمرنا هذا ما ليس فيه، فَهُوَ رَد))، ((الحلال بَيِّنٌ والحرام بَيِّنٌ))، ((الدين النصيحة))، ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك))، ((لا ضرر ولا ضرار))، ((المستشار مؤتمن))، ((الظلم ظلمات يوم القيامة))، ((رفقًا بالقوارير))، وغيرها الكثير.
المرحلة الثانية – التدوين والملاحظة: أحد أهداف التشريع هو إيضاح أحكام الشرع في مختلف شؤون الحياة، كما بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء حياته قولاً وفعلاً وتقريرًا؛ لذلك بدأت الحركات الفقهية بالظهور مع وفاته، بداية مع الصحابة، ومن بعدهم التابعين، وتابعي التابعين، ومن بعدهم العلماء والفقهاء والقضاء والمفتين والمجتهدين باستنباط الأحكام الفقهيّة للمستجدّات من الأمور لأنّهم يعلمون أنّ لكل قضية حكمًا شرعيّا كما في الآية الكريمة: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ}[iv] وعليهم هم تقع مسؤولية الكشف عنه. فلجأوا إلى النصوص الشرعيّة المحدودة نصاً، وأشبعوها بعقولهم المستنيرة من التدبّر والتفكّر والتعمّق والتبصّر، وقد فهموا المطلب الشرعيّ منهم في قوله تعالى: {أفلا يتدبرون القرآن}[v] وذلك لاستنباط الأحكام المطلوبة للمستجدات على الناس على مدى العصور والامتدادات الجغرافيّة التي وصلوا إليها؛ ممّا أنتج خزنة كبيرة من المسائل والحلول، وتطوّر القواعد وبقية الأدوات الشرعيّة، وتسارع هذا الإنتاج الفكريّ وتعاظم مع الفتوحات وتطوّر مُتَطلَّبَات الحياة وتغيّرها مع الظروف المستجدّة، وتتابعت عشرات ألوف الأحكام في كلّ مكان وزمان وظرف.
المرحلة الثالثة – التقعيد: استكمل العلماء والفقهاء والقضاء والمفتون والمجتهدون الملاحظة في مرحلة أكثر تقدّماً من الناحية الفكرية والفقهيّة بتقييد ما تشابه من هذه الأحكام ووضعها في قوالب تعبيريّة تحصر كلّ مجموعة متشابهة أو متناظرة (من هنا تعبير الأشباه والنظائر) من هذه الأحكام في جملة عربية فصيحة مُخْتَصَرة بليغة من جوامع الكَلَم. تعبّر كلّ قاعدة منها عن عدد كبير من الأحكام المتفرّقة عبر أبواب الفقه المتعدّدة أو جوانب الحياة المختلفة وأسموا كلّا منها قاعدة فقهيّة. وتكاد تكون هذه القواعد الفقهيّة من الكليّات، وإن كان من المشهور أن تعتبر هذه القواعد أغلبيّة وليست كليّة لأنّها لا تنطبق بالمطلق على كلّ الأحكام بل قد يكون لها عدد من الاستثناءات والحالات المعاكسة والأحكام الخاصّة.
وبهذا نرى أنّ القواعد الفقهية هي من أهمّ وأعظم الدلالات على نبوغ وإبداع وتفوّق العلماء والفقهاء والقضاء والمفتين والمجتهدين منذ القرون الأولى للبعثة النبويّة الشريفة حيت بدءوا بملاحظة تفاصيل الأحكام المتنوّعة الصادرة من النصوص الشرعية الثابتة المحدودة وإعمال ملكة العقل في هذه النصوص وتدبّرها وفقهها وفقه مقاصدها والإفتاء والاجتهاد فيها من واقع علمه الشرعيّ المتقدّ وبالنظر إلى واقع الحال وظروفه المُسْتَجِدَّة لاستشفاف أحكام لم تكن مكتوبة في النصوص الشرعية. ثم انتقلوا من مجرّد الملاحظة إلى جمع ما تشابه وتناظر وتقارب، ومن ثمّ وضعوها في قوالب أو قواعد كلّ منها تمثّل عددًا كبيرًا من الجزئيات التي كانت لتكون متفرّقة مبعثرة لولا هذا الفكر والجهد الرائع، وأطلقوا عليها اسم “القواعد الفقهية”.
وباستعراض القواعد الفقهية، سنجد بينها القواعد الفقهية الكبرى وهي القواعد المتفق عليها في كلّ المذاهب وتنطبق على الكثير من أبواب الفقه حتى يكاد الفقه أن يكون مَبْنِيًّا عليها. والقواعد الصغرى، ومنها المتفرّعة، وهي أقل شمولا من حيث أبواب الفقه وأقل قبولا من حيث المذاهب. كما سنجد القواعد الفقهية المختصّة بمذهب معيّن أو أكثر لكن دون إجماع عليها. ولكلّ واحدة من هذه القواعد أَدِلَّتَها الشرعيّة من الكتاب الكريم والسنّة الشريفة، كما قد يكون لها استثناءات أيضاً.
كما أنّه اِسْتِكمالاً للموضوع، يجب أن نذكر أنّه توجد أيضاً ضوابط فقهيّة، والضابط الفقهي يشبه القاعدة في وظيفته إلّا أنّه ينطبق على باب واحد من أبواب الفقه، في حين تنطبق القاعدة الفقهية على العديد من الأبواب الفقهية إن لم يكن أكثرها. فقال العلامة تاج الدين السبكي: “والغالب فيما اختص بباب وقصد به نظم صور متشابهة أن يسمى ضابطاً“. ومثالاً للضابط الفقهي، نورد حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: ((أيما إهاب دبغ فقد طهر))[vi]، فمن الواضح أنّه لا ينطبق إلّا على باب واحد من الفقه، ولذلك دعاه العلماء ضابطاً؛ هذا لا يمنع أن يكون بعض العلماء قد ساروا في كتبهم على عدم التفريق بين القاعدة والضابط.
ومن المهمّ أن ندرك جيّدا أنّ القواعد الفقهية بمجملها وجميع متفرّعاتها هي ذات قيمة شرعيّة تشريعيّة بل وقانونيّة عظيمة، كما أنّها تحمل دلالة إضافية على عظمة هذه الشريعة التي جعلت لنفسها من داخلها أدوات خاصة بها تميّزها بالسعة والمرونة والليونة والعالمية لتنطبق في كل مكان وزمان وظرف حتى قيام الساعة.
لكن على الرغم من أهميّة القواعد الفقهيّة، إلّا أنّه لا يجوز استنباط حكم ما بالرجوع إليها حصراً، بل يُستأنس بها لتخريج أحكام جديدة بالإضافة إلى الأدلّة الشرعية والأدوات التشريعيّة الأخرى. إنّها تشبه نظام الإضاءة المستعمل على الطرقات، يبيّنها ويوضّحها وييسّر السير فيها بالتأكيد لكنّه لا يغني عن التنقّل وعن الرحلة المطلوبة للوصول إلى المكان المنشود.
أهميّة ودلالات القواعد الفقهية
علينا بقطف فوائد وثمرات تعلّم القواعد الفقهية لننتفع بما أنجزه علماؤنا الميامين حاملي لواء الحكمة والنور والهدى.
- تسهّل علينا فهم أحكام الوقائع المستجدّة التي لا نصّ شرعيّ فيها، كما تقرّب إلينا الإحاطة بعشرات الألوف من الأحكام الفرديّة المنتشرة في أقرب وقت وتساعدنا في فهمها بأسهل طريق بعيداً عن الكثير من التفاصيل التي قد تسبّب لك بعض التشويش والاضطراب.
- تضبط لنا عشرات الألوف من الأحكام الفرديّة والجزئيات في قاعدة واحدة سهلة علينا في الحفظ والفهم في آن واحد؛ مما يُسَهل استذكار حكم تلك المسائل بمجرد تذكّر القاعدة وفهم دلالاتها ومدى انطباقها، إذ صيغت بعبارات سهلة الحفظ جامعة المعنى وفي ذلك استغناء عن حفظ أكثر الفروع لأنّها تندرج تحت القواعد الجامعة.
- تتيح لنا الاطلاع على الأحكام الشرعية بشكل سهل ميسّر نسبيّاً وإن كنت من غير المتخصصين في الشريعة.
- تضبط لنا دراسة الفقه على ضوء القواعد الفروع المتشابهة وتزيل ما قد يكون بينها من تشابه أو تناقض، وتسهّل ربط الكليّات بالجزئيّات أو العكس؛ في حين أنّ دراسة الفروع مجرّدة عن قواعدها قد تكون أصعب لوجود الكثير من التفاصيل الواردة فيها.
- تظهر عظمة الفقه والفقهاء معًا حيث تظهر تطبيقات الفقه في شتّى دروب الحياة ومختلف الأبعاد التي تعنى بها الشريعة، كما تظهر مدى ليونة وسعة ومرونة التشريع التي تجعلها في مصاف مختلف عن كافة الشرائع الوضعية، كما تبيّن مدى العمل ومستوى الجهد الذي تميّذز به عمل الفقهاء في تخريجهم لهذه القواعد.
- تساعدنا في إدراك مقاصد الشريعة والإحاطة بأهدافها العامة، فتسهم في رسمٍ مركّز وواضح للمقاصد الشرعيّة والحكمة وراء الأحكام المتفرّقة، فتمكّننا من التعرّف بيسر على مقاصد الشريعة بطريقة قريبة وبسيطة بعيدة عن التفصيلات التي قد تغرقنا بكثير من المعلومات تشتّت بها تفكيرنا بعيدا عن التركيز على هذا الهدف.
- تنمّي الملكة الفقهية لدينا وخاصة بإحاطتنا بالكثير من الأدلّة الشرعية من الكتاب الكريم والسنة الشريفة؛ كما تساعدنا في تَبيّن الأوجه المتناسبة بين المتشابهات والمتناظرات وفي إيضاح أوجه الخلاف بين المتنافرات والمختلفات. ومن خلال تنمية هذه الملكة يُمكننا فهم الأحكام الفقهية للوقائع والمستجدّات من الأمور. كلّ هذا من باب التدبّر والتفكّر والتعمّق والتبصّر في القرآن الكريم والسنة الشريفة، والآيات المحفّزة على ذلك كثيرة وهي تستعمل عدّة تعابير مثل بصائر[vii]، والحكمة[viii]، والموعظة[ix]، والتدبّر[x]، وغيرها.
ولا تستكمل المعلومات الأوليّة عن القواعد الفقهيّة دون مختصرٍ لمعنى كلٍّ من القواعد الفقهية الكبرى المشهورة على أن يتبع شرح كلّ منها على حدة بمقال مخصص لذلك في وقت قريب بإذن الله عزّ وجلّ:
- الأمور بمقاصدها (أو الأعمال بالنيات): أي إنّ نتيجة عمل الإنسان (المكلّف) من قبول أو رد أو ثواب أو عقاب مرتبطة بنيته عندما قام بذلك العمل. مَثَّلَا عندما يصلي الإنسان، ترتبط صحة أو بطلان صلاته والثواب أو العقاب عليها حسب نيته: إذا لم يحدد أي صلاة فهي باطلة؛ ويثاب على صلاته الصحيحة إذا ابتغى بها وجه الله تعالى.
- اليقين لا يُزال بالشك: أنّ ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين مثله فلا يُنظر إلى شك طارئ غير مؤكّد، وكذلك الأمر أنّ ما ثَبُت عدم وجوده باليقين فلا يُدعى وجوده بالشك الطارئ. مثلًا، من تيقّن الطهارة وشك في الحدث، فإنه يبقى على حكم الطهارة، لأنّه متأكّد من الطهارة، لكنّه غير متأكد من حصول أي أمر ينقض الطهارة.
- المشقّة تجلب التيسير: المشقّة، أو العسر أو الحرج أو الأذى، التي تستدعي التيسير، أو التسهيل أو الترخيص، هي غير المعتادة أو العادية التي تفوق قدرة احتمال الإنسان (المكلّف) في تأدية العبادة، فيعجز عن ذلك دون أن يتعرّض لأذى محتمل أو مشقة شديدة. ويكون التيسير على قدر المشقة ويستمر بقدر استمرارها. مثلا يمكن لأحدهم الصلاة على الكرسي إلى أن يشفى مما ألمّ به من عارض قويّ يمنعه من السجود دون أذى أو ضرر. وعند شفائه تنتهي الرخصة بالتيسير، ويجب أن يعود إلى الصلاة المعتادة.
- الضرر يزال (أو لا ضرر ولا ضرار): إنّ الضرر والإضرار ممنوعان في الشريعة فلا الضرر ابتداء مقبول، ولا الضرار جزاء ومقابلة لضرر مقبول. فلا يجوز مثلًا بيع غرض ما دون ذكر عيوب معلومة به؛ كذلك إذا تضرّر أحدهم فلا يجوز ردّ الضرر بإنزال ضرر آخر، بل يلجأ للقضاء ليرفع الضرر أو للحصول على تعويض.
- العادة محكّمة: أنّ العادة أو اَلْعُرْف، أي ما تعارف عليه الناس واعتادوه، تكون حكما شَرْعِيًّا في نظر الشرع إذا لم يرد نص صريح بذلك الأمر ولم يعارض الشرع؛ إذ ليس للعادة أو اَلْعُرْف حق تغيير النصوص التي تبقى دائمًا الأقوى. مثلًا إن واجب الزوج الإنفاق على زوجته حسبما هو متعارف عليه ضمن قدرات وضعه المادي؛ كذلك أن يُستعمل ما جرت عليه العادة في بلد معين من كيل معين معروف بينهم في صفقة، ما لم يتم الاتفاق بغير ذلك.
وفي المختصر، فإنّ بعض مبادئ القواعد الفقهية هي: الحد هو قانون تعرف به أحكام الحوادث التي لا نص عليها في كتاب أو سنة أو إجماع؛ وموضوعه القواعد، والفقه من حيث استخراجه من القواعد؛ وثمرته السهولة في معرفة الأحكام الحادثة التي لا نص فيها، وإمكان الإحاطة، بالفروع المنتشرة في أقرب وقت، وأسهل طريق على وجه يؤمن معه التشويش والاضطراب[xi].
هذا ما عندي من فضل الله تعالى ونعمته علىّ، فإن أحسنت فمن الله سبحانه، وإن أسأت أو أخطأت فمن نفسي والشيطان.
وصل اللهم وسلّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العلمين.
سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (*) وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (*) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (الصافات:180-182)
| أسماء المراجع والمصادر |
| تفسير السعدي، البغوي، ابن كثير، القرطبي، والطبري؛ مشروع المصحف الإلكتروني في جامعة الملك سعود |
| تخريج الأحاديث النبوية الشريفة من الموسوعة الحديثية، من موقع الدرر السنية، https://www.dorar.net/hadith |
| معجم المعاني الجامع، الرائد، لسان العرب، القاموس المحيط، وغيرها، من موقع المعاني،https://www.almaany.com/ |
| محمد الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقها في المذاهب الأربعة، دار الفكر، دمشق، تموز 2006. |
| محمد الزحيلي، القواعد الفقهية على المذهب الحنفي والشافعي، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، طبعة ثانية، 2004. |
| إسماعيل عبد عباس د.، تعريف القواعد الفقهية، تاريخ الإضافة: 4/2/2020 ميلادي – 9/6/1441 هجري، من موقع الألوكة الشرعيّة، https://www.alukah.net/sharia/0/138504/ |
| موقع الألوكة الشرعيّة، فوائد تعلم القواعد الفقهية ، https://www.alukah.net/sharia/0/138706/ |
| موقع طريق الإسلام، القواعد الفقهية :المقال الأولhttps://ar.islamway.net/article/76012/ |
| موقع إسلام ويب، /أُعْطِيتُ-جوامع-الكلمhttps://www.islamweb.net/ar/article/173965/ |
| موقع قصة الإسلام، /من-جوامع-الكلمhttps://islamstory.com/ar/artical/444/ |
| الشيخ عبدالرحمن بن فهد الودعان الدوسري، ملخص القواعد الفقهية، تاريخ الإضافة: 24/2/2016 ميلادي – 15/5/1437 هجري، موقع الألوكة الشرعيّة، https://www.alukah.net/sharia/0/99392/ |
| عبد التواب مصطفى، أهمية القواعد الفقهية، موقع منارات، ديسمبر 2014، أهمية القواعد الفقهية/http://www.manaratweb.com/ |
| عماد حمدي البحيري، قاعدة الأمور بمقاصدها معناها وتطبيقاتها العملية، موقع إسلام أون لاين، https://islamonline.net/sahem/قاعدة الأمور بمقاصدها معناها/ |
| الشيخ عبدالرحمن بن فهد الودعان الدوسري، تاريخ الإضافة: 16/5/1437 هجري، شرح قاعدة (اليقين لا يزول بالشك) مع الأمثلة، من موقع الألوكة ، https://www.alukah.net/sharia/0/99021/شرح قاعدة (اليقين لا يزول بالشك) مع الأمثلة |
| أبو الكلام شفيق القاسمي المظاهري، القاعدة الفقهية: العادة محكمة، تاريخ الإضافة: 14/6/2015 ميلادي – 27/8/1436 هجري، من موقع الألوكة الشرعية، https://www.alukah.net/sharia/0/87835/القاعدة الفقهية: العادة محكمة/ |
[i] محمد الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة،
[ii] سَمِعْتُ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: ((مَن يُرِدِ اللَّهُ به خَيْرًا يُفَقِّهْهُ في الدِّينِ، وإنَّما أنا قاسِمٌ واللَّهُ يُعْطِي، ولَنْ تَزالَ هذِه الأُمَّةُ قائِمَةً علَى أمْرِ اللَّهِ، لا يَضُرُّهُمْ مَن خالَفَهُمْ، حتَّى يَأْتِيَ أمْرُ اللَّهِ)). الراوي: معاوية بن أبي سفيان | المحدث: البخاري | المصدر: صحيح البخاري | الصفحة أو الرقم: 71 | خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
[iii] ((فُضِّلْتُ علَى الأنْبِياءِ بسِتٍّ: أُعْطِيتُ جَوامِعَ الكَلِمِ، ونُصِرْتُ بالرُّعْبِ، وأُحِلَّتْ لِيَ الغَنائِمُ، وجُعِلَتْ لِيَ الأرْضُ طَهُورًا ومَسْجِدًا، وأُرْسِلْتُ إلى الخَلْقِ كافَّةً، وخُتِمَ بيَ النَّبِيُّونَ))، الراوي: أبو هريرة | المحدث: مسلم | المصدر: صحيح مسلم | الصفحة أو الرقم: 523.
[iv] وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ ۚ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ (النحل:89)
[v] أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا (محمد:24)
[vi] أخرجه مسلم (366) باختلاف يسير، والنسائي (4241) واللفظ له
[vii] قَدْ جَاءَكُم بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ (*) وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (الأنعام:104-105)
وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي ۚ هَٰذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (الأعراف:203)
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (القصص:43)
هَٰذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ (الجاثية:20)
[viii] كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (البقرة:151)
يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (البقرة:269)
ذَٰلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ۗ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا (الإسراء:39)
[ix] وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (البقرة:231)
هَٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ (آل عمران:138)
۞ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء:58)
وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ۚ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ (هود:120)
وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ (النور:34)
يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ (يونس:57)
[x] أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (النساء:82)
كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ (ص:29)
أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا (محمد:24)
[xi] محمد الزحيلي، القواعد الفقهية على المذهب الحنفي والشافعي، ص 57
