من العصر النبوي حتّى القرن الثالث للهجرة: سلسلة دقيقة فريدة في توثيق وتدقيق السنّة النبويّة.
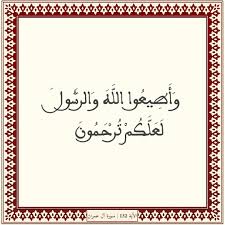
الحمد لله وحدة والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده، اللهم لا علم لنا إلا ما عَلّمْتَنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم عَلِّمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما عَلَّمتنا وزدنا علماً؛ واجعلنا ممن يستمعون القول فيتّبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.
- هل تأخر المسلمون في تدوين السنة النبوية؟
- أولًا: لكن قبل الدخول في التفاصيل، ما هي السنة النبوية؟
- ثانيًا: بدايات التدوين منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
- ثالثًا: التدوين الرسمي المبكر.
- رابعًا: عصر التصنيف الموسّع (القرن الثالث الهجري).
- خامسًا: كيف ميّز العلماء الحديث الصحيح؟
- الخلاصة: الشبهة مغالطة غير صحيحة إطلاقا.
- لائحة المراجع والمصادر.
هل تأخر المسلمون في تدوين السنة النبوية؟
تنتشر بين الحين والآخر شبهات تشكك في مصادر التشريع الإسلامي، مثلما ترددت في بعض المقالات – ومنها ما كتبه “يوسف نوفل” بعنوان «أكثر من 183 سنة مفقودة من تاريخ الإسلام» – دعوى أنّ هناك فجوة طويلة في تاريخ الإسلام، تُقدَّر بـ 183 سنة أو ما يقارب ستة أجيال تناقلت الحديث النبوي مشافهة، دون أن يُكتب فيها، وأن أول من دوّنه هو الإمام البخاري (ت 256 هـ) الذي وُلد بعد هذه الفترة!
هذه الدعوى لا تصمد أمام الدراسة التاريخية المنهجية، التي تفنّدها تمامًا، فإن السنة النبوية – أي ما نُقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير – قد حُفظت ودُوّنت قبل وفاته، وبعلمه وإذنه، ثم استمرت عملية التدوين والتوثيق جيلاً بعد جيل، حتى وصلت إلينا عبر سلسلة دقيقة فريدة في تاريخ توثيق وتدقيق العلوم. لذلك فإنّ هذا الادعاء، رغم انتشاره، ينمّ عن جهل عميق بتاريخ الإسلام ومنهجية علم الحديث، ويقوم على خلط أساسي بين “بداية الكتابة والتدوين” وبين “مرحلة تأليف المصنفات الكبرى الجامعة”.
أولًا: لكن قبل الدخول في التفاصيل، ما هي السنة النبوية؟
السنة النبوية أو الحديث الشريف هو: “ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير“.
والتقرير يعني أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم شخصًا يفعل فعلًا أو يقول قولًا فيقرّه عليه، أي لا يعترض بل يُظهر الرضا.
مصطلح الوحي في لسان الشرع يدل على كلِّ «ما أعلم به الله – سبحانه – رسولَه – صلى الله عليه وسلم – من أمر الدين ليُبلِّغه للناس كافة»، وهو إما أن يكون قرآناً أو سُنَّة. والقرآن الكريم أُوحِيت كلماته من الله – سبحانه وتعالى – إلى الرسول – صلى الله عليه وسلم – ليُبلِّغَها بحروفها، لذلك يُصطَلح على طريقة تبليغه الوحي الجلي أو المتلوّ. بينما أُوحيت السُّنة النبوية الشريفة بالمعنى فقط، كما ورد في القرآن الكريم قول الله تعالى: {مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ § وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ § إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ} (2-4)، وصِيَغُها اللفظية مَنْسُوبَة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم،
ويُصطلح على طريقة تبليغها بالوحي الخفي أو الوحي غير المتلو، وهو ما أوحاه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في قلبه وألقاه في روعه ليقوم بتطبيق وتفسير القرآن، فهي مبينة للكتاب شارحة له، قال الله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} (النحل:44). وبناءً عليه فإنّ السنة النبويّة هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم، وقد أمرنا الله سبحانه باتباعهما وأن نرد إليهما ما تنازعنا فيه، إذ قال تعالى في كتابه الكريم: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} (النساء:59)
ثانيًا: بدايات التدوين منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم
خلافًا للادعاء الوارد في المقالة المذكورة، فإن تدوين السنة بدأ مبكرًا، وبإذن الرسول صلّى الله عليه وسلّم، وأحيانا بأمره، فلم تكن كتب الصحاح مثل صحيح البخاري هي بداية التدوين، بل كانت تتويجًا لجهود علمية ضخمة بدأت منذ عهد النبوة:
- أُذن لبعض الصحابة بالكتابة، مثل عبد الله بن عمرو بن العاص الذي كتب صحيفة سمّاها الصادقة، وكانت تحتوي على نحو ألف حديث بإذن النبي صلى الله عليه وسلم.
- الأمر لبعض الصحابة بكتابة خطبة فتح مكة لأبي شاه
- صحيفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
- صحيفة جابر بن عبد الله رضي الله عنه.
- كما كُتبت وثائق نبوية رسمية مثل “صحيفة المدينة”، ورسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والقبائل.
هذه المرحلة تُسمى مرحلة التدوين الأولي.
ثالثًا: التدوين الرسمي المبكر
بعد عصر الصحابة، جاءت المرحلة الثانية:
- استمر من بقي من الصحابة وبشكل أعمّ تلاميذهم من التابعين في كتابة الحديث وتدوينه في “صُحُف” و”كراريس” خاصة بهم. كان الدافع هو الخوف من النسيان وحرصهم على حفظ الحديث. ورغم أن النقل الشفهي القائم على الحفظ المتقن كان هو السائد، إلا أن الكتابة كانت أيضا وسيلة دعم وتوثيق أساسية.
- وفي عهد الخليفة عبد العزيز بن مروان (ت 85 هـ) بدأ أمرٌ واسع بجمع الأحاديث، وتبعته حركة علمية واسعة في مختلف أنحاء العالم الإسلامي.
- ثم في عهد الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز (ت 101 هـ) أُرسل أمرٌ رسمي إلى ولاته وعلمائه بجمع السنة وتدوينها خشية ضياعها، وهذه لحظة فاصلة في تاريخ التوثيق وتُعرف بـ مرحلة التدوين الرسمي.
في هذه الفترة ظهر عدد كبير من التابعين الذين اهتمّوا بتدوين الحديث، مثل:
- الشعبي (ت 103 هـ)
- أبان بن عثمان بن عفان (ت 105 هـ)
- محمد بن مسلم بن شهاب الزهري (ت 124 هـ)
- ابن جريج بمكة (ت 150 هـ).
- معمر بن راشد (ت 153هـ) في اليمن
- الأوزاعي (توفي 157 هـ) في بلاد الشام.
- سفيان الثوري (توفي 161 هـ) في الكوفة.
- الإمام مالك بن أنس (ت 179 هـ) في المدينة، الذي صنف كتاب الموطأ، وهو أقدم كتاب حديث كامل وصل إلينا مرتبًا على أبواب العلم.
رابعًا: عصر التصنيف الموسّع (القرن الثالث الهجري)
هنا نصل أخيرًا إلى العصر الذي يتحدث عنه أصحاب شبهة “الفجوة”!! وقد جاء بعد ذلك جيل الأئمة الكبار الذين وضعوا ما يُعرف بـ “الكتب الصحاح والسنن”:
- الموطأ للإمام مالك (ت 179 هـ)، جمعه الإمام مالك في المدينة المنورة، بناء على طلب الخليفة أبو جعفر المنصور (ت 158 هـ).
- مسند الإمام أحمد (ت 241 هـ).
- صحيح البخاري (ت 256 هـ).
- صحيح مسلم (ت 261 هـ).
- كتب السنن: لأبي داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه.
هذه المرحلة ليست بداية التدوين بل هي استكمال لمسيرة التدوين، كما هي مرحلة الانتقاء والتمحيص، حيث ميّز العلماء بين الصحيح والضعيف وفق قواعد دقيقة صارمة، وجمع المصنفون أو المحدّثون هذه الأحاديث الصحيحة من مئات الآلاف من الأحاديث المكتوبة والمسموعة. إذن المصنّف أو المحدّث ليس مؤلفًا بالمعنى الحرفي، بل هو جامع للأحاديث النبويّة التي يحكم عليها بالصحّة وفق قواعد وشروط توثيقيّة دقيقة وضعها علماء الحديث لتمييز الحديث الصحيح المقبول من الضعيف غير المقبول.
خامسًا: كيف ميّز العلماء الحديث الصحيح؟
لم يكن نقل الحديث عملية عشوائية، بل رافقه منذ البداية علمٌ صارم هو “علم الرجال” أو “الجرح والتعديل”، وهو بمثابة نظام تحقق تاريخي فريد من نوعه، مهمته دراسة حياة كل راوٍ في سلسلة نقل الحديث للحكم على مصداقيته.
ووضع علماء الحديث قواعد علمية دقيقة صارمة يتمّ فيها نقد علميّ دقيق لرواة الحديث وكيفيّة نقل هذه الرواية من راوٍ إلى آخر، لم يعرفها أي تراث آخر، ومن ذلك:
تعريف الحديث الصحيح بخمسة شروط:
هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه عند الرسول صلّى الله عليه وسلّم، من غير شذوذ ولا علّة قادحة.
- اتصال السند: كل راوٍ تلقى الحديث مباشرةً عمن فوقه، من أوّل السند إلى الرسول صلّى الله عليه وسلّم
- العدالة: أن يكون الراوي مسلما بالغا عاقلا متّصفا بالتقوى ومحاسن الأخلاق.
- الضبط: أن يكون الراوي إمّا ضابط صدر (ذو حفظ قوي) أو ضابط كتاب (يحتفظ بكتابة دقيقة).
- انتفاء الشذوذ: ألا يخالف الراوي الثقة راويا آخرا هو أوثق منه.
- انتفاء العلة: ألا يَكتشف خبراء الحديث خلل خفيّ يطعن فيه.
ملاحظة مهمّة:
عندما يقول العلماء إن الحديث “غير صحيح” فليس معناه أنه بالضرورة “كذب”، بل معناه أنّه لم يثبت بشروط الصحة الخمسة السابقة، وقد يكون ضعيفًا أو غير ثابت السند.
الخلاصة: الشبهة مغالطة غير صحيحة إطلاقا.
الزعم بوجود “183 سنة مفقودة” من تاريخ الحديث هو مغالطة تاريخيّة غير صحيحة إطلاقا؛ لأنّ:
- عملية النقل والتدوين كانت سلسلة متصلة الحلقات بدأت في عهد النبوة، وهي تعد من أدق المنهجيات العلمية في تاريخ نقل المعرفة الإنسانية
- التدوين بدأ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم واستمر في عصر الصحابة، وصولا إلى وضع العلوم والمعايير التي حفظت لنا السنة الشريفة بنهاية المطاف في كتب الصحاح التي نعرفها اليوم.
- عمر بن عبد العزيز أمر رسميًا بجمع الحديث أوائل القرن الثاني الهجري.
- جمعت عشرات المصنفات الحديثية بعد العهد النبويّ، بين الصحابة في الجيل الأول، والتابعين في الجيل الثاني، وتابعي التابعين في الجيل الثالث.
- الإمام مالك (ت 179 هـ) صنف الموطأ، وهو أول كتاب حديث وصلنا كاملاً مرتباً على الأبواب الفقهية، وليس صحيح البخاري كما يشاع خطأ، وقد صنّفه قبل البخاري بقرابة قرنّ.
- الصحيحان وغيرهما لم يكونوا بداية التدوين، بل كانت هذه المصنفات تتويجًا لمسار طويل من الجمع والتحقق.
وكان يوجد خلال هذه المرحلة ازدهارا كبيرا في علم الحديث، مع انطلاق علوم دقيقة متفرعة منه لدعم التوثيق والتمحيص واليوم، لدينا آلاف المخطوطات، وعشرات الآلاف من طرق الرواية، وشبكات معقّدة من الرواة الموثّقين، كل ذلك يُثبت أن السنة النبوية لم تُهمل، بل حُفظت بعناية فائقة، بفضل الله أولًا، ثم بجهود علماء الإسلام عبر القرون. لذلك، يمكننا القول أنّه لا توجد أيّ فجوة زمنية، ولا نسيان، ولا اعتماد على الذاكرة وحدها، بل توجد منهجيّة فريدة بدقتها ومنهجها في حفظ السنة النبويّة وتوثيقها هي من أدقّ ما عُرف في التاريخ، وقد شهد به حتّى الباحثون الغربيون والمستشرقون المنصفون.
لائحة المراجع والمصادر
| مقدمة صحيح مسلم – الإمام مسلم (ت 261 هـ) – تناول فيها شروط الحديث الصحيح ومنهج التوثيق. |
| مقدمة فتح الباري – ابن حجر العسقلاني (ت 852 هـ) – شرح منهجي لصحيح البخاري وتاريخ جمع الحديث. |
| معرفة علوم الحديث لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري (ت. 405 هـ) |
| الكفاية في علم الرواية للإمام الخطيب البغدادي (ت. 463 هـ) – موسوعة في آداب الرواية وطرق النقد. |
| إبن صلاح: المقدمة في علم الحديث (ابن الصلاح الصاوي) — مرجع علمي في أصول علم الحديث. |
| تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للإمام جلال الدين السيوطي (ت. 911 هـ) – شرح ممتاز لمختصر ابن الصلاح. |
| “التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير” – ابن حجر العسقلاني (ت 852 هـ) – مختصر مفيد في مصطلح الحديث، مع شروحات لاحقة مثل “فتح المغيث”. |
| تاريخ التشريع الإسلامي – عبد الوهاب خلاف – فصل خاص عن تدوين الحديث ومراحله. |
| “دراسات في الحديث النبوي الشريف: نشأته وتدوينه وطرق نقله” – محمد عجاج الخطيب – دراسة أكاديمية شاملة، تفنّد شبهات التأخر في التدوين، وتستعرض المراحل التاريخية بدقة. يعتبر هذا الكتاب من أهم المراجع الحديثة التي فصلت تاريخ السنة النبوية منذ عصر النبوة وحتى اكتمال التدوين في القرن الثالث الهجري. يرد الكتاب بشكل علمي ومنهجي على شبهة تأخر التدوين، وهو مكتوب بلغة أكاديمية واضحة. |
| تاريخ تدوين السنة وشبهات المستشرقين – للدكتور حاكم المطيري. يركز هذا الكتاب بشكل مباشر على الرد على الشبهات التي أثارها المستشرقون ومن تبعهم حول تدوين السنة، ويقدم أدلة تاريخية ومنهجية على اتصال عملية التدوين منذ العصر الأول. |
| “السنة النبوية بين أهل الحديث وأهل الرأي” – د. ناصر الدين الألباني – يعرض الأدلة التاريخية والمنهجية بوضوح. |
| “تاريخ تدوين الحديث النبوي” – د. محمد مصطفى الأعظمي – من أهم الدراسات الحديثة التي تردّ على الادعاءات الغربية حول تأخر التدوين، مع وثائق وشواهد تاريخية. |
| محمد مصطفى الأعظمي — Studies in Early Hadith Literature / دراسات في أدب الحديث المبكر (ترجمات ومقالات متوفرة بالعربية/الإنكليزية). ردّ منهجي على بعض أطروحات التشكيك، وتحليل لنصوص التدوين المبكر. |
| “السنة قبل التدوين” – د. محمد عبد الغني حسن – يبحث في مرحلة ما قبل المصنفات، ويبيّن أن التدوين الفردي كان سائدًا منذ القرن الأول. |
| “الحديث النبوي: نشأته وتطوره” – د. عبد الفتاح أبو غدة – عرض مبسّط ومنهجي لتاريخ الحديث، مناسب لغير المتخصصين. |
| السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي للدكتور مصطفى السباعي – كتاب تأسيسي رائع، يرد على الشبهات بلغة واضحة. |
| دفاع عن السنة للدكتور محمد أبو شهبة – كتاب موسوعي يرد على شبهات المستشرقين والمشككين بشكل مفصل. |
| Jonathan A. C. Brown — Hadith: Muhammad’s Legacy in the Medieval and Modern (Available in PDF from the Internet Archive)World (2014, Oneworld / I.B. Tauris). عرض حديث، متوازن، ميسر للقراء العامين والدارسين؛ يناقش كيف جُمعت الأحاديث وكيفية نقدها تاريخيًا ومعاصرًا. يعتبر جوناثان براون من أبرز الأكاديميين الغربيين المعاصرين في دراسات الحديث. يقدم هذا الكتاب نظرة شاملة لتاريخ الحديث، ومنهجية نقده، وأهميته في الإسلام. يعرض آراء المستشرقين النقاد ويرد عليها بأسلوب أكاديمي رصين، ويقر بصحة المنهجية الإسلامية في التوثيق. https://archive.org/details/hadithmuhammadsl0000brow |
| “The Origins of Islamic Law: The Qur’an, the Muwaṭṭaʾ and Madinan ʿAmal” – Yasin Dutton (1999) يحلّل “الموطأ” كأقدم مصدر قانوني إسلامي، ويؤكد أن التدوين بدأ مبكرًا جدًّا. |
| Jonathan A. C. Brown — The Canonization of al-Bukhārī and Muslim (2007, Brill). دراسة متخصصة في كيف وأسباب بروز صحيحَي البخاري ومسلم كمراجع “مقننة”. https://islaambooks.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/10/the-canonization-of-al-bukhari-and-muslim-by-jonathan-brown.pdf |
| “Studies in Early Hadith Literature” by Dr. Muhammad Mustafa Al-A’zami – د. الأعظمي باللغة الإنجليزية، يرد فيه على شبهات المستشرقين ويقدم أدلة على التدوين المبكر. أول دراسة أكاديمية غربية تقوم على تحليل المخطوطات الحديثية المبكرة لإثبات أن التدوين بدأ في القرن الأول الهجري. |
| “The Authenticity of Early Hadith Literature” by Dr. M. M. Azami – دراسة نقدية مفصلة. |
| Harald Motzki — The Origins of Islamic Jurisprudence / Hadith: Origins and Developments (سلسلة أبحاث، Brill) تطبيق منهجيات تحليل السند والنص (تحليل السلاسل) مع نتائج هامة في نقاش تاريخي أكاديمي. موتسكي هو باحث ألماني بارز، استخدم منهجية نقد المصادر (Source-critical method) لتحليل الأحاديث المبكرة، وتوصل إلى أن الكثير من المواد الحديثية تعود بالفعل إلى القرن الأول الهجري، مناقضًا بذلك آراء المدرسة الشكية للمستشرقين. https://books.google.com.lb/books/about/The_Origins_of_Islamic_Jurisprudence.html?id=aNDSwh9ftREC&redir_esc=y |
| G. H. A. Juynboll — The Authenticity of the Tradition Literature (1969, Brill). دراسة تاريخية لنقاشات النقد الحديثي في العصر الحديث، مفيدة لفهم مناقشات القرن العشرين حول الأسانيد. https://brill.com/view/journals/arab/17/3/article-p314_5.xml?language=en&srsltid=AfmBOorewHDhkZ8TAf65wWqkOqgyxUE2tzpKjqJ0Orb6eTzxcDOU9EdZ |
| Joseph Schacht — The Origins of Muhammadan Jurisprudence (1950). دراسة تاريخية مؤثرة تناولت تطور الفقه والحديث؛ مهم قراءتها مع ملاحظة أن استنتاجاته تعرضت لنقد واسع لاحقًا (انظر أعظمَي وموتزكي وحلاّق). https://ia601902.us.archive.org/0/items/schacht-joseph-the-origins-of-muhamaddan-jurisprudence/Schacht%2C%20Joseph%20-%20The%20Origins%20of%20Muhammadan%20Jurisprudence_text.pdf |
| Al-A’zami, Muhammad Mustafa: On Schacht’s Origins of Muhammadan Jurisprudence, Oxford Centre for Islamic Studies & Wiley, 1985. هذا الكتاب هو رد علمي مفصل على نظرية المستشرق “جوزيف شاخت” الذي كان يرى أن الأحاديث هي صناعة متأخرة. استخدم الأعظمي نفس أدوات شاخت النقدية ليثبت خطأ نظريته، وقد أحدث هذا الكتاب أثرًا كبيرًا في الأوساط الأكاديمية الغربية |
| Al-A’zami, Muhammad Mustafa: The History of the Qur’anic Text from Revelation to Compilation: A Comparative Study with the Old and New Testaments, Islamic Academy, Leicester, UK, 2003. |
| Wael B. Hallaq — «The Authenticity of Prophetic Hadith: A Pseudo-Problem» (Studia Islamica, 1999). مقالة نقدية مهمة تعالج جدلية “أصالة الأحاديث” وتضعها في منظور تاريخي وفكري. https://almuslih.org/wp-content/uploads/Library/Hallaq%2C%20W%20-%20The%20authenticity.pdf |
| “Hadith Literature: Its Origin, Development & Special Features” by Muhammad Zubayr Siddiqi – كتاب كلاسيكي قدم السنة للقارئ الغربي بأسلوب أكاديمي. |
| “Studies in Islamic History and Institutions” by Prof. S. D. Goitein – يحتوي على فصول عن تطور العلوم الإسلامية المبكرة. |
| “The Cambridge Companion to the Qur’an” and “The Cambridge Companion to Muhammad” – يحتويان على فصول كتبها باحثون مختلفون عن السنة ومدى موثوقيتها، وتمثل طيفاً من الآراء الأكاديمية. |
| Lucas, Scott C.: Constructive Critics, Ḥadīth Literature, and the Articulation of Sunnī Islam, Brill, Leiden, 2004. |
| Berg, Herbert (ed.): Method and Theory in the Study of Islamic Origins, Brill, Leiden, 2003. |
| Görke, Andreas and Motzki, Harald: “The First Century of Islamic Jurisprudence”, in The Oxford Handbook of Islamic Law, Oxford University Press, 2015. |
| Burton, John: An Introduction to the Hadith, Edinburgh University Press, 1994. |
| نــهــايــة لائــحــة الــمــراجــع والــمــصــادر |
